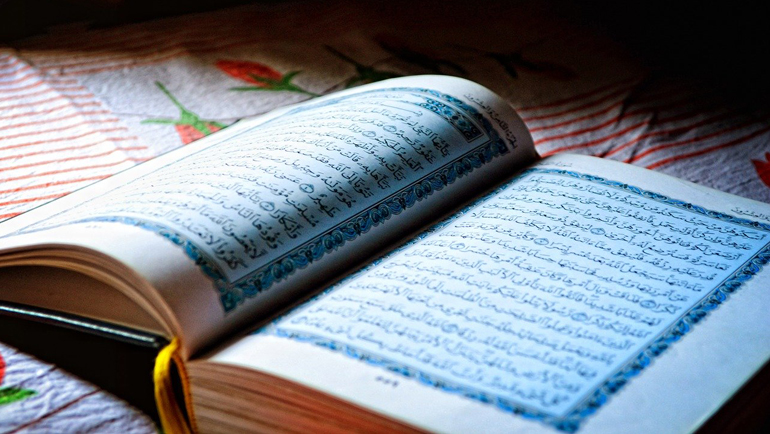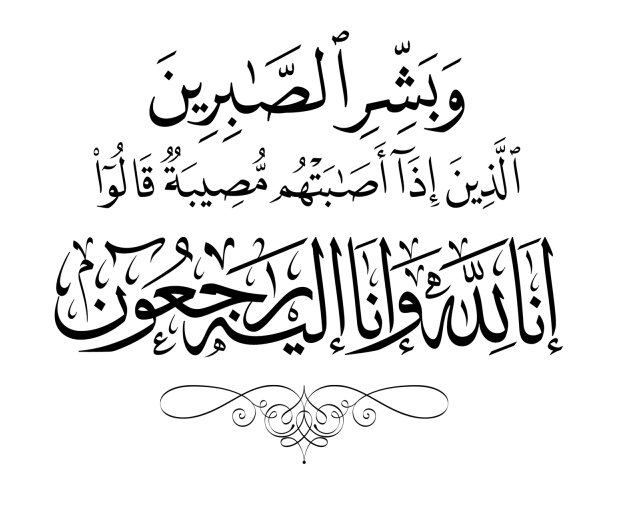الكاتب: ذ عبد الفتاح الفريسي
وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلاها بالرباط يومه الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق لـ 15 سبتمبر 2025م، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق :
” الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام علـى الرسـول الأميـن، وعلـى آلـه وصحابتـه الأكرميـن.
السيـد الأميـن العـام للمجلـس العلمـي الأعلـى،
يسعدنا أن نبلغكم أننا، من موقع ما أناطه الله بنا من حماية الدين بمقتضى إمارة المؤمنين، قد قررنا أن نوجه إليكم هذه الرسالة في موضوع ما ينبغي أن يقوم به العلماء، في ربوع مملكتنا الشريفة، برسم إحياء المناسبة الجليلة التي تحل بالعالم هذه السنة، ألا وهي ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو المبعوث رحمة للعالمين.
حيث يتعين على مجلسكم القيام لهذه الغاية بأنشطة علمية وإعلامية تكون في المستوى الذي يثلج صدرنا وصدر المغاربة، وهم جميعا على المحبة الأكيدة الصادقة للجناب النبوي المنيف، وبهذا الصدد نود الإشارة عليكم بمحاور تندرج في هذا الاتجاه:
أولا: إلقاء الدروس والمحاضرات وتنظيم الندوات العلمية في المجالس والمدارس والجامعات والفضاءات العامة، والقيام بالتواصل الإعلامي الرصين للتذكير والمزيد من التعريف بالسيرة النبوية الغراء وذلك بأسلوب يناسب العصر ويمس عقول الشباب خاصة، مع التركيز على أن أعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هو دين التوحيد، وهذا الإحياء مناسبة سانحة للعلماء لكي يُبيِّنوا للناس أن الترجمة الأخلاقية للتوحيد، في عصرنا، والتي يمكن أن يفهمها الجميع، هي تربية الأجيال على التحرر في حياتهم الفردية والجماعية من الأنانية؛
ثانيا: القيام بأنشطة مماثلة، على نطاق واسع، شكرا لله تعالى على أن جعل إمامة هذا البلد من ذريته صلى الله عليه وسلم، حافظة لعهده، جارية على سُنَنِه، خادمة وحامية لما نزل عليه من الهدي وما شخّصه من الشمائل بمثاله وإسوته؛
ثالثا: القيام بما يناسب المقام شكرا لله تعالى على ما هدانا إليه في مقام وراثة إمارة المؤمنين، الأمر الذي أهّلنا للحرص على توفير الشروط المثلى لأفراد أمتنا حتى يقوموا بكل ما يرضي الله من رعاية شئون الدين الذي جاء به جدنا النبي الأكرم، سواء على سبيل العبادة أو على سبيل غرس مكارم الأخلاق في نفوس المؤمنين والمؤمنات؛
رابعا: التعريف بجهودنا الخاصة وجهود ملوك دولتنا العلوية الشريفة في العناية بتركة النبوة، ولاسيما في ما يتعلق بالحديث الشريف، وبهذا الصدد يجدر بمجلسكم إصدار نشرة علمية لكتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله “الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية “؛
خامسا: التعريف بما برّز فيه المغاربة من العناية بالأَمانات التي بُعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾، فعناية الأمة المغربية بأُولى هذه الأمانات مما يثير إعجاب العالم، ألا وهي عناية المغاربة الفائقة الخاصة بالقرآن الكريم، حفظا وتجويدا وتفسيرا؛
سادسا: التذكير بما برّز فيه المغاربة من العناية بثانية أمانات الرسول الأعظم وهي التزكية، وذلك من خلال ما نبت في أرض المغرب عبر العصور من مؤسسات التربية الروحية المسماة بطرق التصوف، ومعلوم أن الجوهر الذي تقوم عليه تربيتها هو محبة الرسول الذي تنتهي إليه أسانيد هذه الطرق في الدخول على الله من باب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبودية لله؛
سابعا: تعريف عموم الناس بما أجاد فيه المغاربة من صياغة غرر المديح النبوي تعبيرا عن تمجيد الرسول الأكرم في المجالس الخاصة والعامة، إغناء للفطرة السليمة وغذاء للوجدان واستمدادا من روحانيته المحمدية عبر فن السماع؛
ثامنا: إظهار ما برز فيه المغاربة من صياغة الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، من مثال ” ذخيرة المحتاج ” للشيخ المعطى الشرقاوي، وقبله كتاب “دلائل الخيرات ” للإمام الجزولي، هذه الصلوات التي كانت في القرن الخامس عشر الميلادي شعار المغاربة في
جهادهم لتحرير الأراضي المحتلة، ولطالما تعلق المغاربة بالرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة، كما وقع في السياق الذي ألف فيه أبو العباس العزفي في القرن السابع الهجري كتابه “الدر المنظم في مولد النبي المعظم”؛
تاسعا: أن يقوم مجلسكم بالإعداد العلمي اللائق لنشرة محقَّقة لكتاب القاضي عياض الذي عنوانه ” كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى “، وهو كتاب السيرة النبوية الذي اشتهر به المغرب في العالم قبل الاشتهار بكتاب ” دلائل الخيرات “؛
عاشرا: توجيه الناس، لاسيما في هذه الذكرى المجيدة، إلى أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾، وأن تقوم المجالس العلمية بإقامة مجالس
حافلة للصلاة على النبي، مجالس يحضرها القيمون الدينيون وطوائف الذاكرين وعموم الناس وأن يصحب هذه الصلوات التوجه إلى الله تعالى بنية طلبه سبحانه بأن يديم أمنه وأفضاله على بلدنا وأن يمتع شخصنا وأسرتنا بالصحة والعافية التامة وحسن الختام.
هذا ونهيب بكم، من جهة أخرى، للحرص على أن تشركوا في فعاليات إحيائكم هذا وبرامجه رعايانا المغاربة في الخارج، وذلك عبر المجلس العلمي المغربي لأوروبا وغيره من المؤسسات، وعلى نفس المنوال عليكم أن تشركوا إخواننا في البلدان الإفريقية، ولاسيما عبر “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يزيدنا وينفعنا على الدوام بمحبة نبيه وآله وصحبه الكرام، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
بث الرسالة الملكية السامية يتلوها السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أمير المؤمنين، جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم
الإثنين 15 سبتمبر 2025
أمير المؤمنين، جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم
وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلاها بالرباط يومه الاثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق لـ 15 سبتمبر 2025م، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق :
” الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام علـى الرسـول الأميـن، وعلـى آلـه وصحابتـه الأكرميـن.
السيـد الأميـن العـام للمجلـس العلمـي الأعلـى،
يسعدنا أن نبلغكم أننا، من موقع ما أناطه الله بنا من حماية الدين بمقتضى إمارة المؤمنين، قد قررنا أن نوجه إليكم هذه الرسالة في موضوع ما ينبغي أن يقوم به العلماء، في ربوع مملكتنا الشريفة، برسم إحياء المناسبة الجليلة التي تحل بالعالم هذه السنة، ألا وهي ذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو المبعوث رحمة للعالمين.
حيث يتعين على مجلسكم القيام لهذه الغاية بأنشطة علمية وإعلامية تكون في المستوى الذي يثلج صدرنا وصدر المغاربة، وهم جميعا على المحبة الأكيدة الصادقة للجناب النبوي المنيف، وبهذا الصدد نود الإشارة عليكم بمحاور تندرج في هذا الاتجاه:
أولا: إلقاء الدروس والمحاضرات وتنظيم الندوات العلمية في المجالس والمدارس والجامعات والفضاءات العامة، والقيام بالتواصل الإعلامي الرصين للتذكير والمزيد من التعريف بالسيرة النبوية الغراء وذلك بأسلوب يناسب العصر ويمس عقول الشباب خاصة، مع التركيز على أن أعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هو دين التوحيد، وهذا الإحياء مناسبة سانحة للعلماء لكي يُبيِّنوا للناس أن الترجمة الأخلاقية للتوحيد، في عصرنا، والتي يمكن أن يفهمها الجميع، هي تربية الأجيال على التحرر في حياتهم الفردية والجماعية من الأنانية؛
ثانيا: القيام بأنشطة مماثلة، على نطاق واسع، شكرا لله تعالى على أن جعل إمامة هذا البلد من ذريته صلى الله عليه وسلم، حافظة لعهده، جارية على سُنَنِه، خادمة وحامية لما نزل عليه من الهدي وما شخّصه من الشمائل بمثاله وإسوته؛
ثالثا: القيام بما يناسب المقام شكرا لله تعالى على ما هدانا إليه في مقام وراثة إمارة المؤمنين، الأمر الذي أهّلنا للحرص على توفير الشروط المثلى لأفراد أمتنا حتى يقوموا بكل ما يرضي الله من رعاية شئون الدين الذي جاء به جدنا النبي الأكرم، سواء على سبيل العبادة أو على سبيل غرس مكارم الأخلاق في نفوس المؤمنين والمؤمنات؛
رابعا: التعريف بجهودنا الخاصة وجهود ملوك دولتنا العلوية الشريفة في العناية بتركة النبوة، ولاسيما في ما يتعلق بالحديث الشريف، وبهذا الصدد يجدر بمجلسكم إصدار نشرة علمية لكتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله “الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية “؛
خامسا: التعريف بما برّز فيه المغاربة من العناية بالأَمانات التي بُعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾، فعناية الأمة المغربية بأُولى هذه الأمانات مما يثير إعجاب العالم، ألا وهي عناية المغاربة الفائقة الخاصة بالقرآن الكريم، حفظا وتجويدا وتفسيرا؛
سادسا: التذكير بما برّز فيه المغاربة من العناية بثانية أمانات الرسول الأعظم وهي التزكية، وذلك من خلال ما نبت في أرض المغرب عبر العصور من مؤسسات التربية الروحية المسماة بطرق التصوف، ومعلوم أن الجوهر الذي تقوم عليه تربيتها هو محبة الرسول الذي تنتهي إليه أسانيد هذه الطرق في الدخول على الله من باب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبودية لله؛
سابعا: تعريف عموم الناس بما أجاد فيه المغاربة من صياغة غرر المديح النبوي تعبيرا عن تمجيد الرسول الأكرم في المجالس الخاصة والعامة، إغناء للفطرة السليمة وغذاء للوجدان واستمدادا من روحانيته المحمدية عبر فن السماع؛
ثامنا: إظهار ما برز فيه المغاربة من صياغة الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، من مثال ” ذخيرة المحتاج ” للشيخ المعطى الشرقاوي، وقبله كتاب “دلائل الخيرات ” للإمام الجزولي، هذه الصلوات التي كانت في القرن الخامس عشر الميلادي شعار المغاربة في جهادهم لتحرير الأراضي المحتلة، ولطالما تعلق المغاربة بالرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة، كما وقع في السياق الذي ألف فيه أبو العباس العزفي في القرن السابع الهجري كتابه “الدر المنظم في مولد النبي المعظم”؛
قال الكاتب المصري هاني ضوة إن الزكاة ليست مجرد فريضة مالية تقليدية، بل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل في المجتمعات المسلمة، وأضاف أن الزكاة تمثل وسيلة عملية لتوزيع الثروة على نحو عادل، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحد من مظاهر الفقر والتهميش.
وأشار عضو المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، في مقال توصلت به هسبريس، إلى أن فهم أحكام الزكاة وتطبيقها بدقة لم يعد ترفًا فقهيًا، بل ضرورة دينية واجتماعية لضمان استقرار المجتمعات وتماسكها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتطورات سريعة في أنماط الكسب والمعاملات المالية.
وأشار ضوة إلى أن دعوة الملك محمد السادس باعتباره أميراً للمؤمنين للمجلس العلمي الأعلى من أجل إعداد فتوى شاملة بشأن الزكاة على الدخل الحديث تمثل خطوة ذات بعد إستراتيجي، إذ تهدف إلى ربط القيم الإسلامية بواقع الحياة المعاصرة، واعتبر أن هذه الدعوة الملكية تعكس وعيًا عميقًا بأهمية تفعيل الزكاة كممارسة حية تتجاوز الإطار النظري، لتصبح أداة عملية تسهم في تحقيق التوازن بين الأفراد والمجتمع، مشددًا على أن الفتوى المرتقبة من شأنها أن توفّر للمواطنين مرجعية شرعية دقيقة تعينهم على أداء الزكاة بما يتلاءم مع تعقيدات الاقتصاد الحديث.
وأوضح الكاتب أن من شأن الفتوى أن توضح المسائل الفنية المتعلقة بالنصاب والمقادير وأوقات الإخراج، ما يعيد الثقة في المرجعيات الدينية الرسمية ويقلّص من تأثير الاجتهادات الفردية والمعلومات المغلوطة المنتشرة على المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن تفعيل الزكاة على هذا النحو يعزز الدور التوجيهي للمؤسسات الدينية، ويُسهم في بناء وعي مجتمعي متماسك حول أدوار العبادات في خدمة المصالح العامة.
كما أكد ضوة أن تنظيم الزكاة من خلال مؤسسات رسمية أثبت نجاعته في بعض الدول العربية، مشيرًا إلى التجربة المصرية، حيث يشرف “بيت الزكاة والصدقات” على عملية جمع الزكاة وتوزيعها تحت إشراف شيخ الأزهر، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، ويتيح تمويل مشاريع تنموية لتحسين معيشة الفقراء، وأبرز أن هذه التجربة يمكن أن تلهم المغرب في مساعيه لتقنين الزكاة وإدارتها بآليات مؤسسية فعالة.
وأضاف الكاتب المصري أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى وعي المواطنين واستعدادهم للامتثال للتوجيهات الجديدة، إضافة إلى كفاءة الجهات المعنية في وضع أنظمة شفافة وعادلة لجمع الموارد وتوزيعها؛ كما أكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مواكبة هذه المبادرة بالتوعية والتعبئة المجتمعية.
وقال صاحب المقال إن الزكاة بهذا المفهوم تصبح أكثر من مجرد التزام ديني، بل تتحول إلى أداة فعالة لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على أسس من العدالة والتضامن، لافتا إلى أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بأسلوب أخلاقي ومسؤول، وتبرهن في الوقت ذاته على مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة التحولات، من دون التفريط في ثوابتها.
واعتبر ضوة أن دعوة الملك محمد السادس تأتي في سياق رمزي خاص، إذ تتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الـ1500 لميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يضفي على المبادرة بعدًا روحيًا وتربويًا، متابعا بأن الربط بين هذه الذكرى التاريخية وإحياء فريضة الزكاة يعكس رؤية متكاملة توظّف الدين في خدمة القيم المجتمعية والاقتصادية الراهنة.
وفي ختام مقاله أكد الكاتب المصري أن الفتوى المنتظرة ليست مجرد معالجة فقهية لقضية تقليدية، بل تمثل تحولًا في مسار تفعيل الزكاة في المغرب، بوصفها أداة إصلاح اقتصادي واجتماعي، ودعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الرؤية من خلال الالتزام الواعي بالزكاة والمشاركة في بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة.
خَلَق اللَّهُ سبحانه الخَلْقَ، وأمرهم بعبادتِه، وبَعَث إليهم رُسُلَه رحمةً بهم، وأنزل مع كلِّ واحدٍ منهم كتاباً لكمال الحُجَّة والبيان، قال سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾، وخَصَّ سبحانه القرآنَ الكريمَ من بين سائرِ الكتب بالتَّفضيل، جُمِعت فيه محاسنُ ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فكان شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلِّها، فكلُّ كتابٍ يشهد القرآنُ بصِدْقِه فهو كتابُ اللَّه، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾.
لم يُنزَّل من السَّماء كتابٌ أهدى منه، وهو أحسنُ الأحاديثِ المُنَزَّلة من عند اللَّه ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثَانِيَ﴾، وقد مَنَّ اللَّهُ على رسولِه به فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، وجعله شرفاً له ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «أَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابُ اللَّهِ»، وهو شَرَفٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ وعَمِلَ به من هذه الأُمَّة، قال عز وجل: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾.
وَصَفه اللَّهُ بأنَّه مجيدٌ وكريمٌ وعزيزٌ، وتحَدَّى الخَلْقَ بأن يأتوا بمِثْلِه، أو بمِثْلِ عَشْرِ سُوَرٍ منه، أو بمِثْلِ سورةٍ منه؛ فصاحتُه وبلاغتُه ونَظْمُه وأسلوبُه أمرٌ عجيبٌ بديعٌ خارقٌ للعادة، أعجزت الفُصَحاءَ والبُلَغاءَ معارضَتُه، فإنَّه ليس من جنس الشِّعر ولا الرَّجَز، ولا الخَطابة ولا الرَّسائل، ولا نَظْمُه نَظْمُ شيءٍ من كلام النَّاس عَرَبِهم وعَجَمِهم، آياتُه جَمَعت بين الجَزالة والسَّلاسة، والقوَّة والعُذوبة، سَمِعَه فُصَحاء العرب وبُلغاؤهم وأربابُ البيان فيهم فأقرُّوا بتفرُّدِه، قال الوليد بن المُغِيرة – وهو من سادات الكفَّار البُلغاء -: «وَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمُ بَرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي، وَلَا بِأَشْعَارِ الجِنِّ، وَاللَّهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئاً مِنْ هَذَا».
ومع إعجازه سَهَّل اللَّهُ على الخَلْقِ تلاوتَه، ويَسَّر معناه؛ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾، قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يَسَّرَهُ عَلَى لِسَانِ الآدَمِيِّينَ، مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ اللَّهِ».
والإعجازُ في معناه أعظمُ وأكثرُ من الإعجازِ في لَفْظِه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «جَمِيعُ عُقَلَاءِ الأُمَمِ عَاجِزُونَ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَعَانِيهِ، أَعْظَمَ مِنْ عَجْزِ العَرَبِ عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثْلِ لَفْظِهِ».
القرآنُ قولٌ فَصْلٌ مُشتَمِلٌ على قواعد الدِّين والدُّنيا والآخرة، فيه العقائدُ، والأحكامُ والتَّشريعاتُ، والأخلاقُ والقَصَصُ، والأخبارُ والمواعظُ، وأُسُسُ السَّعادة والفلاحِ، قال عنه سبحانه: ﴿هَذَا هُدىً﴾.
آياتُه مُحْكَمةُ الألفاظ مُفَصَّلةُ المعاني، فآيةٌ واحدةٌ فيه بيَّنت الحكمةَ من خَلْقِ الثَّقلَيْن؛ ﴿وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وجزءٌ من آيةٍ أَصَّلت الدِّين؛ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾، وثلاثُ كلماتٍ مَنِ استجاب لها سَعِد في الدُّنيا والآخرة؛ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾، قال ابن القيِّم رحمه الله: «لَيْسَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْبَرَاهِينِ وَالآيَاتِ عَلَى المَطَالِبِ العَالِيَةِ مِثْلَ القُرْآنِ».
لا تَفْنى عجائبُه، ولا يُحاط بمعجزاتِه ممَّا في آياتِه وسُوَرِه، فآيةُ الكرسيِّ أَفْضَلُ آيةٍ في كتابِ اللَّهِ تَحْفَظُ العبدَ، و«لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ» (رواه البخاري)، و«مَنْ قَرَأَهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ» (رواه النسائي)، و«مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ – أَيْ: مِنَ الشَّرِّ -» (متفق عليه)، وثلاثُ آياتٍ إذا قالها العبدُ قال اللَّهُ: «حَمَدَنِي عَبْدِي، وَأَثْنَى عَلَيَّ، ومَجَّدَني؛ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾» (رواه مسلم)، و«مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» (رواه مسلم).
وسورةُ الفاتحة أعظمُ سورةٍ فيه (رواه البخاري)، قال شيخ الإسلام رحمه الله: «تَأَمَّلْتُ أَنْفَعَ الدُّعَاءِ فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ العَوْنِ عَلَى مَرْضَاتِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الفَاتِحَةِ فِي ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾»، وسورتان قصيرتان أُنْزِلت لَيْلاً لم يُرَ مثلُهنَّ قطُّ – أي: في التَّعويذ من شَرِّ الأشرار -؛ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (رواه مسلم).
وآياتُه شفاءٌ من الأسقام، قال أبو سعيد الخدريُّ رضي الله عنه: «نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبَرَأَ» (متفق عليه)، قال ابن القيِّم رحمه الله: «كُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالفَاتِحَةِ، فَأَرَى لَهَا تَأْثِيراً عَجِيباً، فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَماً، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَبْرَأُ سَرِيعاً».
آياتُه أبكت السَّادةَ العظماء؛ كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صَلَّى لم يُسْمِعِ النَّاسَ من البكاء، وصَلَّى عمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه مرَّة الصُّبحَ في أصحابِه فسُمِع نَشِيجُه من آخر الصُّفوف وهو يقرأ سورة يوسف: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.
وإذا قَرَع القرآنُ السَّمع سَرَى إلى القلوب فأبكاها خشوعاً، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لابن مسعودٍ رضي الله عنه: «اقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾، رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ» (متفق عليه)، وقرأ جعفرُ بن أبي طالب رضي الله عنه صَدْراً من سورة مريم على النَّجاشيِّ فبَكَى حتى أخضَلَ لِحيَتَه – أي: ابتلَّت -، وبَكَتْ أساقِفَتُه – أي: رؤساء الدِّين منهم – حتى أخضَلُوا مصاحفَهم (رواه أحمد).
القرآنُ المجيدُ يأخذ بالألبابِ، وهو أقوى سبيلٍ للدَّعوة إلى الإسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «ابْتَنَى أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا – أَيْ: يُخْرِجُهُمْ مِنْ دِينِهِمْ إِلَى دِينِهِ -» (رواه البخاري).
وسَمِعَ جُبَيْر بنُ مُطْعِم رضي الله عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطُّور فلمَّا بَلَغ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ قال: «كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ» (رواه البخاري).
واستمعتِ الجِنُّ للقرآن فآمنوا، واغتبطوا، وقالوا مُتحدِّثين بنعمةِ اللَّه عليهم: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ﴾.
ولو أنزل اللَّهُ القرآن على جبلٍ لتَذَلَّل وتَصَدَّع من خَشْيةِ اللَّه؛ حَذَراً من أنْ لا يُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهِ عز وجل في تعظيم القُرآنِ، فأَمَرَ اللَّهُ النَّاسَ أنْ يأخذوه بالخَشْيةِ الشَّديدةِ والتَّخشُّعِ.
آياتُه بَدَّلت أحوالَ الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لمَّا نزل تحريم الخمر، وسَمِع عمرُ رضي الله عنه قولَه تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ﴾ قَالَ: «انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا» (رواه أحمد)، و«هَرَقُوهَا حَتَّى جَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ» (متفق عليه)، وحين نزلت: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ﴾ أي: الجَنَّة ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قال أبو طلحة رضي الله عنه: «إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ» (متفق عليه).
وآيةٌ ثبَّتَت الصَّحابةَ رضي الله عنهم في أشدِّ مصيبةٍ نزلت بهم؛ حين توفِّي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأنكر بعضُهم موتَه لهَوْلِ ما سمعوا؛ تلا أبو بكر رضي الله عنه قولَ اللَّهِ تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ﴾، قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ إِلَّا حِينَ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَراً إِلَّا يَتْلُوهَا» (رواه البخاري).
ولمَّا نزلت آيةُ السِّتر والعفاف ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ﴾ قالت عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ – أَيْ: أَكْسِيَةً لَهُنَّ- فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» (رواه البخاري).
آياتُه تزيد في الإيمان ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً﴾، ولمنزلة القرآن عند اللَّه أجرُ تلاوتِه بعدد الحروف؛ بل مضاعفة، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (رواه الترمذي).
ولِمَا في القرآن من الكنوز العظيمة حَرَصَ الصَّحابةُ أن لا يفوتهم شيءٌ منه إذا نَزَل، قال عمرُ رضي الله عنه: «كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ يَنْزِلُ يَوْماً، وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» (رواه البخاري).
وأهلُ الكتاب القائمون بمقتضاه يفرحون بالقرآن لِمَا في كُتُبِهم من الشَّواهد على صِدْقِه والبِشارة به؛ قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.
كتابٌ مُعجِزٌ جَعَله سبحانه آيةً على صِدْقِ نُبُوَّةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، لا يزول بموته؛ بل باقٍ إلى يوم القيامة، وإذا استمرَّ المُعْجِزُ كَثُرَ الأتباعُ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ» (متفق عليه).
وتكفَّل سبحانه بحِفْظِ هذه المعجزة فلا تُحَرَّف ولا تزول، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ في خُطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، وَقَالَ: وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ المَاءُ» (رواه مسلم)، قال النَّوويُّ رحمه الله: «مَعْنَاهُ مَحْفٌوظٌ فِي الصُّدُورِ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الذَّهَابُ؛ بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الأَزْمَانِ».
وكان الصَّحابة رضي الله عنهم إذا تذكَّروا انقطاعَ الوَحْيِ بعد وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، قال أبو بكر لعمرَ رضي الله عنهما: «انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا» (رواه مسلم).
ولعُلُوِّ القرآن أعلى اللَّهُ أهلَه إلى المراتب العالية، والمنازل الرَّفيعة، وعَظَّم حُرْمَتَهم، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ القُرَّاء ويَأْتَمِنُهم ويحزن لموتهم، وقَنَتَ على مَنْ قتلهم شهراً، ولم يَقْنُت على أحدٍ زمناً طويلاً إلَّا على مَنِ اعتدى عليهم.
وسار الخلفاء الرَّاشدون على توقير أهلِ القرآن وإجلالِهم ومعرفةِ قَدْرِهم، فكان عمر رضي الله عنه يُدْنِيهم منه ويُقَدِّمهم في مَجْلِسه ويجعلهم أهلَ مَشُورَتِه، قال القرطبيُّ رحمه الله: «تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَاتُ بِأَنَّ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ جَمَعُوا القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَأَجْلِ سَبْقِهِمْ إِلَى الإِسْلَامِ وَإِعْظَامِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ».
واللَّهُ لم يُنْزِلْ كتاباً من السَّماء فيما أَنْزَلَ من الكُتُبِ المُتعدِّدةِ على أنبيائِه، أَكْمَلَ ولا أَشْمَلَ ولا أَفْصَحَ ولا أَعْظَمَ ولا أَشْرَفَ من القرآن، وهو من فَضْلِ اللَّه ورحمتِه على العباد، مَنْ فَرِح به وبالإسلام فقد فَرِح بأعظم مفروحٍ به، وهما خَيْرٌ مِمَّا يُجْمَعُ مِنْ حُطَامِ الدُّنيا، وأموالِها وكنوزِها؛ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾، ومَنْ أحبَّ القرآن فقد أحبَّ اللَّهَ، قال ابن القيِّم رحمه الله: «وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ، فَانْظُرْ مَحَبَّةَ القُرْآنِ مِنْ قَلْبِكَ، وَالتِذَاذَكَ بِسَمَاعِهِ».
فالسَّعيدُ مَنْ صَرَف هِمَّتَه إلى تعلُّم القرآن وتعليمه، والمُوَفَّقُ مَنْ اصطفاه اللَّه لتعظيمه وتعظيم أهلِه والتَّذكيرِ به.
أعوذ باللَّه من الشَّيطان الرَّجيم
﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾.
وختاما:
فمَنْ أراد الهدايةَ فعليه بالقرآن، ومَنْ أراد الانتفاعَ به فليجمع قَلْبَه عند تلاوتِه وسماعِه، وليستشعر كلامَ اللَّه إليه؛ فإنَّه خطابٌ منه للعبيد على لسان رسولِه، وليس شيءٌ أنفعَ للعبد في معاشِه ومعادِه وأقربَ إلى نجاتِه من تلاوةِ القرآن، ومَنْ تدبَّر القرآنَ طالباً منه الهُدَى تبيَّن له طريقُ الحقِّ.
د. عبد المحسن القاسم
أولا: البنية وإعادة القراءة
لماذا إعادة قراءة القرآن؟ ولماذا نقترح بنية القرآن مدخلاً لهذه الاستعادة؟، سؤالان مشروعان يحفزهما ما للمصطلحين من براقة الحداثة والمعاصرة، ولما يضمرانه في الاستعمال الغالب من نزعة فلسفية ونقدية في شتى الاستعمالات، فالقراءة ستحيل إلى ما عرف بالقراءة المعاصرة للقرآن، والبنية ستحيل إلى البنيوية في سياقاتها الفلسفية واللغوية والاجتماعية، وبالتالي فإن العنوان سيبدو من الوهلة الأولى آتياً في هذا السياق.
إن طرح الأسئلة حول العنوان إن جاء ليحترز مما قد يتبادر منه فإنه لا ينفي الأثر المعرفي الذي آلت إليه مناهج البحث في دراسة القرآن الكريم بفعل تطور النظريات الفلسفية واللغوية وغيرها، وكذلك أثر التوظيف السلبي لها في دراسة القرآن الكريم، إذ أدى هذا النمط من القراءات المعاصرة إلى ميلاد وعي أعمق بمركزية القرآن في الفكر الإسلامي، ومحوريته في مشاريع النهوض والتجديد.
أما لماذا إعادة القراءة؟ سيتبادر إلى الذهن أيضاً المنحى التوظيفي، والاتكاء على التأويل المفتوح تحت شعار “حمال أوجه” وبالتالي تمرير ما يريد القارئ من القرآن أن يقوله، وعليه فمظنة البراءة لا تبدو غالبة في مشاريع إعادة قراءة القرآن، والقراءة المعاصرة، واستخدام المناهج الحديثة في دراسته.
إن تجربة المسلمين الحديثة في دراسة القرآن تبرر هذه المخاوف والتوجسات، فالعهد بدراسة القرآن هو المنحى التفسيري المعهود الذي لم يتقدم بمناهج التفسير إلا جزئياً، فالجهد انصب على إعادة الصياغة والترتيب الشكلي (تحريراً)، مع إضافات في تفسير بعض الآيات وتوجيه النظر فيها ترجيحاً أو استنباطاً ونقداً لتفاسير سابقة (تنويراً)، مع طغيان نزعة المفسر المذهبية أو الفكرية، فيما بقيت المقاربات الأخرى في دراسة القرآن تعتمد على هذا التفسير التجزيئي بدرجة كبرى كالتفسير الموضوعي الذي بقي بطيئاً في التطور ولم يتبلور منهجياً بشكل يمكن اعتباره إضافة نوعية ومستقلة، لكنه شكل نواة لتطور الدرس القرآني، وبالمقابل ظهرت نزعة ثورية انتفضت على مناهج المفسرين واستغلت ثغرات فيها وفي علوم القرآن، مدعية قراءة معاصرة للقرآن تتوسل مناهج مختلفة وأحياناً تجمع متناقضات منها، ما أدى بها إلى الخروج بخليط من الأفكار غير المنسجمة والمتناقضة أحياناً ادعيت دراسة للقرآن الكريم، مما أدى إلى زيادة الوثاقة بالمنهج التقليدي لدراسة القرآن ومرجعيته، والشك والحذر من أي مقاربة جديدة أو غير مألوفة في درس القرآن الكريم. ومما زاد هذا الحذر ما آلت إليه كثير من المقاربات تبعاً، إذ اتخذت موقفاً من السنة النبوية ومرجعيتها، فضلاً عن الموقف من التراث الإسلامي عموماً ما جعل الدراسة القرآنية غير التقليدية تهمة بذاتها.
في هذا الجو المشحون بالهواجس والشكوك التي تغيب فيها تقاليد المعرفة وأصول البحث والنقد سيبقى الدرس القرآني بين نزعتين: الأولى تأسر تطوره في أقفاص ما انتهى إليه المفسرون، وتبقي نوافذ له مما يؤكد ذلك من تطورات العصر، والنزعة الثانية تجعل الدرس القرآني كأي مقاربة لأي نص، فيخضع لتطور الدرس اللغوي والأدبي والتاريخي، ويبقى ميدان تجربة للقارئ يقرأ فيه ما يشاء.
لكن البحث العلمي الهادئ والرصين كان ولا يزال بعيداً عن هذه النزعات، وهو الكفيل بأن يحقق الإبداع في الدراسة والرصانة في المنهج والإخلاص في الهدف، فأن يكون ما وصل إليه المفسرون هو نهاية المطاف في فهم القرآن لا يمكن أن يكون منسجماً مع حقيقة أنه كتاب لا يخلق على كثرة الرد، وكونه كتاباً إلهياً لا يحيط بكلماته زمان أو مكان، “قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا” [سورة الكهف/الآية:109]، وإذا كانت دراسة القرآن لا تتجاوز ما قدمه المفسرون فهذا يعني أننا لم نقدم جديداً لفهم القرآن، ومن المعلوم أن الجديد ليس بالضرورة نقداً أو نقضاً للقديم، بل لا يمكن أن يكون هناك جديد من غير بناء على ما هو قديم ترميماً أو إعادة بناء، وبالتالي فتصور الجديد نسخة من القديم أو نقيضاً له بالضرورة تحكم غير منطقي، وتعقيم لبذور الإبداع، كما أن تصور الجديد في فهم القرآن أنه قول فيه من غير منهج منسجم هو الآخر تقول على النص لا يستحق النظر.
فإعادة دراسة القرآن تستمد مشروعيتها من طبيعة القرآن نفسه فهو نص أنزل ليقرأه كل من يدخل في خطابه، ولا يحده زمان أو مكان، كما أن ما كتبه المفسرون هو تجربة في فهم القرآن، إن كشفت عن جوانب من معانيه وأحكامه فإن جوانب أخرى ما تزال مكنونة فيه، وإن لم تتقدم مناهج المفسرين على مر العصور في كشف جوانب جديدة، فإن سؤال المنهج يبدو ملحاً والمدخل إلى دراسة القرآن يبدو مفصلياً في إمكانية إضافة جديدة في فهم النص واكتناه معانيه.
فإذا كان البحث الجديد مشروعاً فلماذا نسميه قراءة وليس تفسيراً؟ والإجابة ترجع إلى بعدين الأول أن ما سيدخل تحت اسم القراءة من دراسة يختلف عما عرف من منهج للتفسير، فالاختلاف المنهجي بحد ذاته مبرر لاختلاف المصطلح، ومن ناحية أخرى فإن تسمية القرآن بهذا الاسم تحمل دلالة للواجب نحوه وهو القراءة وهي ليست مجرد تلاوة لفظية ونطق لسان إنما تشمل التدبر والفهم، والمعنى اللغوي للقراءة كما تؤكد المعاجم هو الجمع لأي شيء، فقراءة القرآن جمع له ولا معنى لجمع النص إلا إدراك معانيه من متفرق ألفاظه المتسقة فيه، ومعنى الجمع هذا سنربطه بتعبير آخر له ارتباط بالنص القرآني هو الكتاب.
أما البنية في تعريفها الفلسفي البسيط فهي نسق عقلاني يحدد وحدة الشيء وهي القانون الذي يفسره[1]، هذان البعدان من مفهوم البنية هما ما سنستفيد منه في مقاربتنا، مع إدراكنا لذيول مفهوم البنية وتبعاته في مختلف السياقات والمذاهب، إلا أن هذا البعد الذي حددنا هو بعد حيادي يحيل إلى افتراض وجود نظام داخلي للشيء يعبر عن وحدته وكما يتضمن روابط عقلانية تفسره، ولئن كانت البنيوية كمذهب ترفض أثر أي عنصر خارجي في تفسيره، فإن مفهوم البنية إن كان يتضمن مبدأ التفسير الداخلي فإنه لا ينحصر فيه بالضرورة، لكنه يستلزم أن يكون هو الحاكم في التفسير والمنطلق.
وبالتأمل في القرآن يمكننا أن نجد فيه مفهوم البنية كأفضل مثل لها، فهو نسق واحد مترابط ترابطاً عقلانياً تعبر عنه روابط كثيرة بين آياته وسوره، وكمنطلق في الإسلام فإن للقرآن هيمنة مطلقة على ما دونه من نصوص، وأدق ما يمكن أن يكشف هذه الهيمنة هو بنية القرآن كنظام محكم، من هذا المنطلق يأتي اختيارنا لتعبير البنية كمدخل للقراءة.
ثانياً: جذور وعي القدماء ببنية النص القرآني
نزل القرآن الكريم بلغة عربية، وكان العرب والمسلمون يتلقون القرآن ويفهمون معانيه بما يمتلكونه من فصاحة وبلاغة، ويدل وصفهم للقرآن على وعيهم به كنص يعبر عن بنية متكاملة، نجد ذلك في وصف المشركين للقرآن جملة بأنه سحر، وهو وصف ينسحب على مجمل ما سمعوه من القرآن ككل، وكذلك تعبير الوليد بن المغيرة واصفاً القرآن بقوله: “إن لقوله حلاوة وإن عليه طلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى”[2]، وهذه الأوصاف لا تتأتى إلا من خلال النظر إلى القرآن بمجمله لا بأجزاء منه، ووصف السيدة عائشة رضي الله عنها أخلاق الرسول عندما سئلت عنها قائلة: “كان خلقه القرآن” وربطت ذلك بتفسير قول الله عز وجل “وإنك لعلى خلق عظيم”[3]، وكأنها تعبر عن فهم عميق لتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كجملة متكاملة.
وبعد عصر رسول الله صبى الله عليه وسلم كان الصحابة بما تلقوه من علم عن الرسول وبما يمتلكونه من معرفة بلغة العرب يفسرون كتاب الله قدر طاقتهم، ولم يُفَسَّر القرآن جميعه، وإنما فُسِّر بعض منه، وهو ما غمض فهمه، فكان التفسير يتزايد تبعاً لتزايد الغموض، وكان واضحاً أنهم كانوا يفهمون القرآن جملة واحدة، يؤشر على ذلك قِلَّة الاختلاف بينهم في فهم معانيه، واكتفاؤهم بالمعنى الإجمالي، وكانوا لا يُلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلاً.
وفي عهد التابعين غلب على التفسير نزعة طلب الرواية لتوظيفها في التفسير فسادت الإسرائيليات وحذفت الأسانيد التي قل فيها الصحيح، وأصبح البحث عن معاني القرآن من خارجه، من خلال الروايات بالخصوص، فجاء عصر التدوين تالياً وولد علم التفسير المدون وهو مثقل بالإسرائيليات والروايات المشكوك فيها، حتى إن أقدم تفسير مدون وصل إلينا تفسير مقاتل (150هـ) يعتبر الأنموذج للروايات الدخيلة في علم التفسير، وتلا ذلك نشأة مدارس التفسير المأثور والتفسير بالرأي والتفسير الفقهي… واستمر التفسير إلى عهدنا يتطور ويتكرر بنفس المنهجية التحليلية التي تتعامل مع القرآن كأجزاء وسور تفسر واحدة تلو الأخرى، مع تفاوت في العمق ومنزع التحليل، إذا فالنمط الغالب على منهجية التفسير هي التجزيء والبحث في المفردات والألفاظ، والاستنباط الفقهي والتفريع الدلالي لكل آية وما تتضمنه من معنى، وهذه المنهجية لا تكشف عن جوانب كلية في القرآن، بل حتى حول ما له صلة بالآية المدروسة لما للنظرة الكلية من أثر في اكتشاف البيان القرآني حول المسألة.
وبموازاة هذه المنهجية التحليلية كانت هناك محاولات أخرى فردية تتجه إلى دراسة القرآن من زاوية أخرى هي الرؤية الشاملة والكلية للقرآن الكريم، بدأ ذلك من منطلق الدفاع عن القرآن والبحث في إعجازه، وأول ما ظهر مع المعتزلة الذين اهتموا بمواضيع القرآن نظراً لاستنادهم إلى النص القرآني في احتجاجهم ودفاعهم.
فظهرت مع الجاحظ أولى تلك المحاولات، حيث تتبع في كتابه الحيوان ذكر النار في القرآن[4]، كما كان الجاحظ من أوائل من تنبه إلى أهمية دراسة القرآن من حيث أسلوبه ونظمه، ومع القاضي عبد الجبار تتبلور نظرية النظم التي تعتبر أهم وجه من وجوه الإعجاز، وتمثل منطلقاً مهماً للرؤية الكلية للقرآن، إذ تركز على النسق والروابط بين الكلام كما يقول الجرجاني “ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض”[5]، وقد أشار الشاطبي إلى ضرورة اعتبار الجزئي والكلي في النظر للسورة القرآنية فيرى أن النظر في السورة له اعتباران، الأول من جهة تعدد قضاياها، والاعتبار الثاني من جهة النظم، فلا بد من النظر في أول الكلام وآخره بحسب الاعتبار، فاعتبار جهة النظم لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميع السورة بالنظر[6]، فكانت نظرية النظم من التنظيرات المبكرة للنظر الكلي إلى القرآن بالتركيز على الأنساق والروابط بين أجزاء النص وتراكيبه.
في سياق آخر نجد محاولة ثانية ومبكرة أيضاً هي النظر إلى أجزاء من النص تشكل شبكة من المفاتيح لفهمه وربط المعنى بين مختلف أجزائه، نلحظ ذلك من خلال علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، والذي يُعنى بالألفاظ القرآنية المستخدمة على أكثر من وجه، وهو علم لصيق بعلوم العربية لكنه منحصر في السياق القرآني وتعود جذوره إلى القرن الثاني الهجري، وإن كان يبدو علماً يركز على الألفاظ والمفردات فإنه في جوهره يكشف عن جوانب من بنية النص القرآني، لاسيما محاولات اكتشاف الروابط بين مختلف هذه الوجوه والنظائر، يبرز ذلك في تأويل النظائر بالاعتماد على اللغة لا المأثور، وإرجاعها إلى أصل واحد، نجد ذلك عند الحكيم الترمذي في كتابه “تحصيل نظائر القرآن” إذ ينفي فيه تعدد المعاني، لوجود علاقة واضحة بينها جميعاً، وحاول الترمذي تطبيق نظريته على إحدى وثمانين لفظاً[7]، وبهذا الرابط بين النظائر المتعددة في النص القرآني الذي أشار إليها الحكيم الترمذي يتم اكتشاف جانب من شبكة المعاني المنثورة في بنية النص، وهي ما يمكن اعتبارها كلمات مفتاحية لفهم بنية النص كالذي عرف في المناهج اللغوية الحديثة… وقريب من مقاربات الوجوه والنظائر ما عرف بعلم الغريب، حيث كانت بعض المؤلفات فيه كمفردات الراغب الأصفهاني تكشف عن ربط بين مختلف الألفاظ المنثورة في القرآن، وهو ربط يشبك المعنى بين مختلف السور، وقد تطورت دراسات المفردات القرآنية عموماً، وأصبحت مدخلاً جديداً لفهم بنية النص، وأفردت بالبحث، وظهرت العناية بفكرة المصطلح القرآني[8]، والهاجس فيها هو الوعي بأهمية اكتشاف المعنى في القرآن من خلال بنيته.
ثالثاً: الوعي الحديث بأهمية بنية القرآن
يمكن أن نسجل محطات مهمة في وعي المحدثين من الباحثين في الدراسات القرآنية بأهمية بنية القرآن كمدخل لدراسته، ويمكن أن نسجل منها بالخصوص المحطات التالية:
1. الوحدة الموضوعية والتفسير الموضوعي
ظهر حديثاً ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم[9]، وهي فكرة قديمة تجد جذورها عند الجاحظ، لكنها استحضرت مؤخراً كمنطلق لما غدا يعرف بالتفسير الموضوعي، الذي يسعى إلى تتبع موضوع ما في جميع القرآن، أو اكتشاف موضوع يشكل رابطاً لكل سورة بمفردها، وفي هذا المنحى في الدراسة إدراك لأهمية النظرة الكلية للقرآن واكتشاف المعنى من مجمله لا من أجزائه، لكن معظم المحاولات في التفسير الموضوعي لم تحقق الهدف إذ انطلقت من الجزء إلى الكل من خلال تجميع ما ورد في التفسير التحليلي وتركيبه بما هو عليه، فلم تختلف إلا صورة البحث وقالبه فقط ومكمن ذلك افتقارها إلى المنهجية الشمولية المنضبطة[10].
2. الكلمات المفتاحية والرؤية القرآنية للعالم
أسهم المستشرقون بجهد مهم في الدراسات القرآنية وتركوا آثاراً متعددة، لكن الخلفية الاستشراقية حالت دون إسهام عدتهم المنهجية في تقديم نقلة نوعية في فهم القرآن ودراسته، إذ ظلت في إطار تفسير الظاهرة القرآنية وإرجاعها إلى تراث كتابي أو تأويل تاريخي أو تفكيكها من الداخل، ولم تتميز معظم الدراسات الاستشراقية بالجدية والصرامة المنهجية التي يمكنها التأثير في فهم القرآن، لكننا نجد استثناء مع الباحث الياباني توشيهكو إيزوتسو Toshihiko Izutsu (مختار)، بعد إسلامه، الذي قدم تجربة متميزة في دراسة القرآن دراسة دلالية، حاول من خلالها اكتشاف الرؤية القرآنية للعالم، وكان المنطلق واضحاً في عمله وهو التعامل مع القرآن كبنية متكاملة، والبحث فيه من خلال الكلمات المفتاحية لاكتشاف محتوى هذا النص، فحاول في كتابه “الله والإنسان في القرآن: دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم”[11] تطبيق علم الدلالة، وحاول اكتشاف النظام المفهوميّ الذي يعمل في القرآن، فتعامل مع المفهومات الفرديّة كجزء من البناء العامّ، أو البنية المتكاملة Gestalt التي اندمجت فيها. ويوضح في مقدمة كتابه أنّ التعابير المفتاحيّة التي تؤدّي وظيفة حاسمة في صياغة نظرة القرآن إلى العالم بما فيها اسمُ “الله” تعالى، ليس منها ما كان جديدًا ومبتكرًا، بل كانت كلّها تقريبًا مستخدمةً قبْل الإسلام. وعندما شرع الوحْيُ الإسلاميّ باستخدامها كان النظامُ كلُّه، أي السّياقُ العامُّ الذي استُخدمت فيه، هو الذي صدم مشركي مكّة بوصفه شيئًا غريبًا وغير مألوف وغير مقبول، تبعًا لذلك، وليس الكلمات الفرديّة والمفهومات نفسها. ويقول ههنا: “الكلماتُ نفسُها كانت متداولةً في القرن السّابع [الميلاديّ]، إن لم يكن ضمن الحدود الضيّقة لمجتمع مكّة التجاريّ، فعلى الأقلّ في واحدة من الدّوائر الدّينيّة في جزيرة العرب؛ ماجدّ هو فقط أنّه دخلت أنظمةٌ مفهوميّة مختلفة. والإسلامُ جمعَها، دمجَها جميعًا في شبكةٍ مفهوميّة جديدة تمامًا ومجهولة حتّى الآن”[12].
إن تجربة إيزوتسو قدمت إضافة نوعية في الدراسات القرآنية من جهة إعطائها نموذجاً تطبيقياً لدراسة بنية القرآن المتكاملة، وكيفية استثمارها في توضيح الرؤية القرآنية للقضايا المركزية التي تحدث عنها، وهي منهجية استثمرت علوم اللغة القديمة والحديثة بطريقة أمينة لا تستهدف التوظيف الاستشراقي المعهود، إنما قادت دراسته إلى نتائج محكمة تؤكد تماسك القرآن وانسجام بنيته، ويقدم إيزوتسو بتجربته المنهجية وما استخدمه من أدوات في تحليل بنية القرآن، وإن لم تكن كلها جديدة أو مبتكرة، إضافة نوعية في الدراسات القرآنية يمكن تطويرها والبناء عليها تنظيراً وتطبيقاً، ويمكنها أن تقدم جديداً في قراءة القرآن وفهم معانيه واكتشاف جوانب جديدة من إعجازه، ومربط الإبداع في عمله الانطلاق من بنية القرآن كمدخل للقراءة.
الوحدة البنائية للقرآن المجيد
في إطار الجهود الحديثة المدركة لأهمية بنية القرآن نجد تأصيل الدكتور طه جابر العلواني للموضوع تحت عنوان “الوحدة البنائية للقرآن المجيد” والتي يقصد بها “أن القرآن المجيد واحد لا يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدّد فيه أو التجزئة في آياته، أو التعضية بحيث يقبل بعضه، ويرفض بعضه الآخر، فهو بمثابة الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو الآية الواحدة، وإذا كانت قد تعددت آياته وسوره وأجزاؤه وأحزابه؛ فذلك التعدد ضرورة لا غنى عنها في التعليم والتعلّم، والتنزيل لتغيير الواقع وإبداله. فلم يكن في مقدور الإنسان أن يستوعب قرآنا يتصف بكل صفات القرآن ويأخذه الإنسان أو يتبناه بوصفه ذا وحدة بنائية لا تختلف عن وحدة الكلمة في حروفها، ووحدة الجملة في كلماتها وأركانها، ووحدة الإنسان في أعضائه”[13]، ويعتبر أن معنى أي آية لن يستقيم ويتضح ما لم تقرأ في سياقها وموقعها وبيئتها وكذلك بإدراك سائر العلاقات بين الآية والقرآن كله[14]، ويتتبع الدكتور العلواني جذور الوعي بمسألة بنائية القرآن فيرجعها إلى البلاغيين ومسألة النظم، والقول بوحدة السورة، وينقد القراءة التجزيئية للقرآن، والتي لا تلحظ الروابط بين كل آية والقرآن ككل، وفيما قدمه الدكتور العلواني دعوة واضحة إلى النظرة الشاملة للقرآن والتعامل معه كبنية واحدة، لكن القارئ كان ينتظر من مقاربة “الوحدة البنائية” أن تقدم نموذجاً تحليلياً وأدوات منهجية للموضوع، وقد قدم الدكتور العلواني مثالاً للوحدة البنائية في السورة التي سلم بها جمهور المعنيين بالدراسات القرآنية، وما قدمه من أمثلة سبق إليه الشاطبي[15] من المتقدمين ومحمد عبد الله دراز من المتأخرين[16].
المفردة القرآنية كأداة لتحليل الخطاب
من المقاربات المهمة في دراسة القرآن من مدخل بنيته دراسة المفردة القرآنية كأداة لتحليل الخطاب، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام خاص وتأصيل منهجي في دراسة الصديق الأستاذ عبد الرحمن الحاج الذي قدم أطروحة متميزة بعنوان: “دلالة المفردة القرآنية: دراسة لسانية أصولية مقارنة”[17] حاول فيها تتبع المنظور الأصولي واللغوي ومقارنته بالمنهج اللساني الحديث في مقاربة المفردة القرآنية، وقد جمع في دراسته بين التنظير ومحاولة التطبيق الجزئي التي قادته إلى اكتشاف ما أسماه “المركز المفهومي” الذي يدور الخطاب القرآني حوله، و”المحور التركيبي” لكل سورة وللقرآن ككل، وبالعموم فإن دراسته تمثل مدخلاً مهماً لتطوير منهجية البحث في الدراسات القرآنية، ومن مدخل بنية القرآن بشكل أساسي.
رابعاً: بنية القرآن (كلمات وكتاب)
إن أهم ما في البنية أنها نسق عقلاني يحدد وحدة الشيء وهي القانون الذي يفسره، والنسق العقلاني يكتشف من خلال مفردات البنية وأجزائها والقانون الذي يفسرها هو الروابط والعلاقات بين الأجزاء، وبهذا المعنى فإن النص القرآني كما أشرت يمثل نموذجاً لهذا المعنى، بل إن القرآن نفسه يشير إلى ضرورة اكتشافه من خلال هذه الزاوية، فسياق حديث القرآن عن الكلمات والكتاب يشير إلى انتظام القرآن كبنية متكاملة ونظام واحد.
فتأتي كلمات الله[18] على صورتين تكوينية تتمثل بالكون والأشياء، وتكليفية تتمثل بالنصوص المتضمنة للتعاليم الإلهية، فالكلمات هي أجزاء الكون وأجزاء النص، وهي قابلة للقراءة والمعاينة والفهم والاعتبار، فالكون المخلوق أثر بارز قد أُمر الإنسان بتدبره والنظر فيه، وكذلك كلمات الله الأخرى التي وصفها الله بأنها لا تنفد ولو نفدت طاقة الإنسان في قراءتها وملاحظة قوانينها وسننها، وهذه المقابلة بين كلمات القرآن وكلمات الكون لها دلالتها على الانتظام والدقة، وكون هذه الأجزاء دالة على كل تنضوي فيه ويمكن للمتأمل فيها أن يصل إلى تلمس جوانب هذا الكل.
وكلمات الله التكليفية باجتماعها تشكل الكتاب، وكلماته التكوينية باجتماعها تشكل الكون، وهذا تناظر آخر بين الكتاب (القرآن) والكتاب (الكون) المأمور بقراءتهما، وينتظم مفهوم الكتاب في القرآن (بمعناه غير اللغوي) ضمن محورين متكاملين: الكتاب الإلهي المنزل على الرسل، والكتاب الإلهي المحيط بالكون وقد سمي بأم الكتاب واللوح المحفوظ، ودلالة هذا الكتاب رمزية تحيل على النظام الوجودي والسنن الإلهية التي تحكم الكون وتسيره[19].
وفي تسمية القرآن بالكتاب دلالة على مفهوم البنية الذي أشرنا إليه، فكل ما ذكر في الكتاب من معان لغوية قريب بعضه من بعض وهو الجمع بين شيئين أو أكثر، فالكتاب هو المجموع من الحروف والكلمات الدالة على مقصود كاتبها، ويستلزم ذلك معنى لازماً له وهو الخط الذي تجمع من خلاله الحروف والكلمات، وبالتالي فالكتاب يشتمل على معنيين هما الجمع مع الانتظام، وهما ما نلحظه في كتاب القرآن وكتاب الكون، فرمز بالكتاب إلى النظام الوجودي الذي يسير الكون الذي خلقه الله وفق سنن ثابتة، فعُبِّر عنه بالكتاب لكون مفردات الكون تجتمع كلها لتشكل وحدة كما تجتمع الحروف والكلمات لتشكل كتاباً، فالمخلوقات تجتمع وتنتظم بالقانون الإلهي كما تجتمع الحروف والكلمات بالسطر الحامل للمعنى لتشكل كتاباً.
فالجمع بين الأجزاء من خلال نظام معين هو البنية التي ينبغي الانتباه إليها وفهمها، وقد أشار القرآن إلى الأجزاء (سماها الكلمات) وإلى حصيلة اجتماعها (سماها الكتاب) ومنها ما هو نصي تكليفي ومنها ما هو كوني، ومهمة الإنسان تجاهها هي القراءة، وبالتالي اكتشاف الكل من خلال أجزائه والجزء من خلال الكل، وهذا معنى اكتشاف القرآن من خلال مفرداته وفهم مفرداته من خلال مجموعه، وكذلك فهم الكون من خلال الذرة وفهم الذرة من خلال النظام الكوني، في تقابل محكم بين بنيتين تقودان إلى التعرف على الخالق وما أودعه من سنن تشريعية وتكوينية.
أخيراً…
إن اكتشاف إحكام آيات القرآن وتفصيلها يتضح أجلى وضوح من خلال الدرس البنيوي للقرآن الذي لا يفصل بين أجزائه وبين كليته، ولئن أدرك دارسو القرآن الكريم جوانب من ذلك، فإن التأصيل المنهجي لهذا الجانب لا يزال ضعيفاً، ولم يستثمر كما ينبغي، هذا فضلاً عن قلة الجانب التطبيقي الذي يعتبر أساسياً في بناء المنهج واختباره، وإن الحاجة لمحلة لإحياء الوعي بأهمية بنية القرآن كمدخل لإعادة القراءة، كونها تفتح أفقاً للإبداع في فهم القرآن وتدبر معانيه، كما أن هذه الحاجة تتأكد لتفعيل مكانة القرآن في التشريع؛ أعني حاكميته على غيره من النصوص، والانطلاق منه كمصدر للتشريع.
الهوامش
1. انظر: الموسوعة الفلسفية، ط: 1، معهد الإنماء العربي 1986، 1/198. 2. انظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ط: 3، المكتب الإسلامي–بيروت، 8/403. 3. انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط: مؤسسة قرطبة–القاهرة، 6/91. 4. يرجع الباحثون إلى الجاحظ جذور التفسير الموضوعي، انظر: سامر عبد الرحمن رشواني، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، (رسالة ماجستير-جامعة القاهرة 1423هـ-2002م ) ستصدر قريباً عن دار الملتقى بحلب. 5. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المقدمة، صفحة: ق، تحقيق :رشيد رضا، ط: دار المعرفة-بيروت 1978. 6. انظر: الشاطبي، الموافقات، ط: دار المعرفة-بيروت 1975، 4/415. 7. انظر: سلوى محمد العوا، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، القاهرة: دار الشروق، ط: 1/1998م، ص: 23، وحول علم الوجوه والنظائر انظر: هند شلبي، مقدمة تحقيقها لكتاب التصاريف ليحيى بن سلام. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 1980م. 8. انظر: عبد الرحمن حللي، المفاهيم والمصطلحات القرآنية: مقاربة منهجية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد: 35، شتاء 2004. 9. الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم عنوان كتاب أصله أطروحة دكتوراه قدمها محمد محمود حجازي في أصول الدين بالأزهر سنة 1967، وكانت أول دراسة متخصصة تعالج أحد الأسس التي يستند إليها التفسير الموضوعي، وهو مفهوم الوحدة، واستطاع أن يقدم عدداً من الدراسات التطبيقية التي تؤكد مفهوم الوحدة وتدعمه، إن على مستوى القرآن أو على مستوى السورة. 10. انظر حول التفسير الموضوعي: زياد خليل محمد الدغامين، منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، عمان: دار البشير، ط:1/1995م، سامر عبد الرحمن رشواني، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، م.س. 11. صدر كتاب إيزوتسو Izutsu لأول مرة عام 1964 وعنوانه: God And Man In The Koran: Semantics of The Koranic Weltanschauung ، عن معهد كيو للدراسات الثقافية واللغوية في طوكيو، وقد ترجم ترجمة متميزة من قبل الأستاذ الدكتور عيسى العاكوب الأستاذ في كلية الآداب بجامعة حلب، وصدرت عن دار الملتقى بحلب عام 2007، كما صدرت للكتاب ترجمة أخرى في نفس العام عن المنظمة العربية للترجمة ببيروت أعدها الدكتور هلال محمد جهاد. هذا وللباحث إيزوتسو دراسة أخرى لا تقل أهمية حول المفهومات الأخلاقية في القرآن: Structure of the Ethical Terms in the Koranوقد صدرت عام 1959م، وكذلك قام بترجمتها الدكتور العاكوب وستصدر قريباً عن دار الملتقى بحلب. 12. انظر: عيسى العاكوب، مقدمة الترجمة، ص: 11. 13. انظر: طه جابر العلواني، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، ط:1 مكتبة الشروق–القاهرة 2006، ص: 14. 14. انظر: العلواني، م.س ص: 18. 15. يقدم الإمام الشاطبي نموذجاً للوحدة الموضوعية للسورة من خلال سورة المؤمنين التي يراها نازلة في قضية واحدة هي موضوع المكيات من السور، والتي ترجع معانيها إلى أصل واحد هو الدعاء على عبادة الله، انظر: الموافقات، 4/416 وما بعدها، م.س. 16. يستند الدكتور محمد عبد الله دراز إلى الشاطبي في القول بوحدة السورة، ويطبق ذلك على سورة البقرة تحت عنوان (نظام المعاني في سورة البقرة) ضمن كتابه: النبأ العظيم، ط: دار القلم–الكويت 1970، ص: 163. 17. رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت، 2006. 18. انظر: عبد الرحمن حللي، الأسماء والكلمات: دراسة مفاهيمية قرآنية، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، العدد: 19 ، السنة العاشرة، فبراير 2006م. انظر: عبد الرحمن حللي، الكتاب: دراسة مفاهيمية قرآنية، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، العدد: 21، الجلد الحادي عشر، 2007م.
الدكتور عبد الرحمن حللي
المصدر: arrabita
- عمران الغيام: برنامج التعليم العتيق للموسم الدّراسي.
- سندس فاقيهي: برنامج التعليم العتيق، بميزة حسن.
- عبد الخالق عروى: برنامج التعليم العتيق، بميزة حسن جدا.
منذ ستة وعشرين سنة على جلوسه على العرش، ومنذ الخطاب الملكي الأول، ومنذ اللقاء الأول بين الملك محمد السادس وشعبه الوفي، أظهر كلاهما الوفاء والولاء لعقد البيعة الشرعية المتبادل، واجتازا معًا العراقيل والصعوبات، واحتفلا معًا بالإنجازات والانتصارات…
فتلاحم العرش والشعب ليس مادة للاستهلاك الإعلامي، بل هو حقيقة أثبتتها أحداث مختلفة على أرض الواقع، وأرّخت له خطابات ملكية سامية.
جوانب متعددة وكثيرة يمكننا الحديث عنها وإثارتها بمناسبة احتفالاتنا بالذكرى السادسة والعشرين على جلوس الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين… إذ لا يمكننا اختزالها في هذا الحدث أو تلك القرارات الاستراتيجية، لكنه قاد بكل تأكيد “ثورات هادئة” قوية وعميقة في كل المجالات وفي كثير من الملفات، أولها مغربية الصحراء، ومبادرة الحكم الذاتي، والعودة للبيت الإفريقي، والبنية التحتية، وفي مجالات القانون والتشريع والحريات والعدالة وحقوق الإنسان، والمفهوم الجديد للسلطة، ومدونة الأسرة، والإنصاف والمصالحة، والتقرير الخمسيني، وإعادة هيكلة الشأن الديني، وأحداث مؤسسات خاصة بمغاربة العالم… وغيرها كثير.
الأشغال والرافعات في كل بقاع المملكة، وفي كل شبر من الوطن، هناك إعادة هيكلة ومشاريع أحلام في الرياضة والصحة والتراث اللامادي جارية التحقيق.
فكان المواطن والوطن هو النقطة الأساسية في أجندة جلالة الملك محمد السادس. كان حاضرًا بكل ثقله المعنوي والدستوري والتاريخي والديني، سواء بصفته رئيسًا للدولة المغربية، أو بصفته أميرًا للمؤمنين، سواء في مشروع إعادة صياغة مدونة الأسرة، أو برامج التنمية المستدامة والتشغيل والصحة والتغطية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، أو في قضايا مغاربة العالم، حيث كان المدافع الأول عن قضاياهم وانتظاراتهم، سواء داخل المغرب أو خارجه.
أو أثناء تقديمه لقراءاته النقدية البنّاءة وتشريحه الموضوعي والواقعي في خطاباته السامية، لأن: “الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم…”
ومادام الشيء بالشيء يُذكر، فإن احتفالات سنة 2025 تقتضي منا تسليط الضوء على مفخرات هذه السنة، وأولها توقيع العهد الجديد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، وزيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب عقب الاعتراف القوي بمغربية الصحراء… وما تلا ذلك من اعترافات وازنة كاعتراف بريطانيا والبرتغال في شهر يوليوز، أو استقبالات ذات أبعاد ودلالات استراتيجية كاستقبال وزراء خارجية الساحل في شهر أبريل 2025.
لكن يبقى القرار الاجتماعي والمجتمعي الأهم خلال سنة 2025 هو إهابة أمير المؤمنين بعدم ذبح أضحية عيد الأضحى، والاكتفاء بالشعائر الأخرى كإقامة صلاة العيد، والقيام بأعمال الإنفاق وصلة الرحم.
فبعد سنوات جفاف عجاف تضرر منها القطيع، وبعد محنة اقتصادية تضررت منها فئات واسعة من المجتمع المغربي، جاءت الإهابة الملكية لرفع الحرج عن العديد من المواطنين في حالة عسر.
لقد كانت الرسالة الملكية ليوم 26 فبراير 2025 بخصوص تلك الإهابة جامعة مانعة، إذ جاءت: “من منطلق الأمانة المنوطة بنا كأمير للمؤمنين، والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجب رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير…”.
الإجماع الوطني القوي، سواء داخل المغرب أو لدى مغاربة العالم، والانخراط في تنزيل هذه الإهابة الملكية بخصوص عيد الأضحى، زاد من قوة العروة الوثقى بين العرش والشعب.
أعتقد أن انشغال الأجندة الملكية بالتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، جعل الشغل الشاغل للملك محمد السادس هو المواطن، والبحث عن أمنه وسلامته من خلال تعزيز الأجهزة الأمنية والقضائية، وأمنه الصحي من خلال أحداث منظومة متكاملة للصحة، سواء ما يتعلق بالموارد البشرية أو الصناعات الدوائية، وأمنه الغذائي والطاقي من خلال إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
كل هذه الانشغالات المهمة والاستراتيجيات الاجتماعية، جعلت من المملكة المغربية مملكة مواطِنة، وضعت في صلب أجندتها واهتماماتها المواطن، وجعلت من الملك محمد السادس، نصره الله، الملك المواطن والملك الإنسان.
المصدر : هسبريس
*تعـــزيـــــة*
ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة *الحاج الحبيب المهنديز* مؤسس مدرسة الحاج البشير القرآنية وأحد رعاتها.
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الفريسي أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة مدرسة الحاج البشير الإدارية والتربوية إلى أسرة الفقيد، بأصدق عبارات التعازي وعظيم المواساة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وينعم عليه بعفوه ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويكرم نزله ويوسع مدخله.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
*عبد الفتاح الفريسي*
مدير عام مؤسسة الحاج البشير
تمارة – المملكة المغربية